
تتناول النسخة الثانية من تقرير الاتحاد من أجل المتوسط حول التكامل الإقليمي، الصادرة في العام المُصادف للذكرى لسنوية الثلاثين لعملية برشلونة، حالة الترابط الاقتصادي الأورومتوسطي، وتُقدِّم توصيات سياساتية قائمة على الأدلة لتعزيز التكامل كمحرّك للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية.
ويركّز هذا التقييم القائم على البيانات، الذي نشره الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على خمس مجالات: التجارة، والتمويل، والبنية التحتية، وتنقّل الأفراد، والتعليم العالي والبحث العلمي. ويستند التقرير إلى النسخة الأولى الصادرة عام 2021، مُحدِّثًا الإطار التحليلي من خلال إدراج ثلاثة أبعاد عرضية جديدة: النوع الاجتماعي، والرقمنة، وحماية البيئة.
لا يزال التكامل الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية دون الإمكانات المتاحة، نظرًا للتحديات المستمرة التي تواجه حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد والأفكار. فمنذ عام 2021، تعرّضت المنطقة لصدمات حادّة، من بينها الحرب في أوكرانيا، التي عطّلت سلاسل التوريد وأثّرت على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأسعار، بالإضافة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط، الذي يقوّض القدرة على الصمود وجاذبية الاستثمار والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
ومع ذلك، ساهمت تطوّرات أخرى بشكل إيجابي في دعم التكامل، مثل زيادة التبادلات مع دول الخليج، والجهود الشاملة المبذولة على مستوى القارة الإفريقية. كما يشير التقرير إلى أهمية ربط البنية التحتية لتعزيز التجارة، والاستثمار، والابتكار، والمهارات، والتنويع الاقتصادي، ويبرز فرص التكامل الأعمق التي يتيحها الانتقال الأخضر ونماذج التنقّل المتطورة.
التجارة
شهدت التجارة البينية في السلع نموًّا ملحوظًا، مع مؤشرات على التحوّل نحو تجارة ذات قيمة مضافة أعلى وتعميق سلاسل القيمة الإقليمية.
تمثل التدفقات التجارية في المنطقة الأورومتوسطية حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي، حيث شكّلت ثلث إجمالي الصادرات العالمية في عام 2022، بقيمة بلغت 7.2 تريليون دولار أمريكي. ورغم أن القيمة الإجمالية للصادرات قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 1996، فإن حصتها من التجارة العالمية لا تزال أقل مما كانت عليه في أوائل العقد الأول من الألفية، حين بلغت ذروتها عند 40%. وفي داخل المنطقة، يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز: ففي عام 2022، نُسبت إليه 94% من الصادرات الداخلية، أي ما يقارب 3.9 تريليون دولار أمريكي، على الرغم من زيادة التكامل التجاري بين تركيا وغرب البلقان وشمال إفريقيا.
يمكن أن تشمل التدابير غير الجمركية، مثل اللوائح الفنية والمعايير وإجراءات التخليص الجمركي والمتطلبات البيئية، بشكل كبير على الوصول إلى الأسواق وتكاليف الامتثال والتدفقات التجارية، مما يخلق عقبات أمام الشركاء الذين يفتقرون إلى القدرات التكنولوجية أو المالية. وقد تُساهم مبادرة توحيد قواعد المنشأ للمنتجات داخل منطقة عموم أوروبا-المتوسط في التخفيف من هذه العقبات. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي تدابير مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة تكاليف التصدير وتقليل القدرة التنافسية للاقتصادات التي تحاول الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
شهد التطور الصناعي في المنطقة مسارات متباينة، لكنه يسجّل عمومًا نموًّا قويًّا في صادرات الآلات والكيماويات ومعدات النقل، مما يشير إلى التحوّل نحو صناعات أكثر تقدمًا وأنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. وفي المقابل، تُظهر قطاعات أخرى، مثل المنسوجات، اتجاهات متراجعة، مما يسلّط الضوء على الحاجة إلى التكيّف والابتكار للحفاظ على القدرة التنافسية في السوق العالمية.
ارتفعت الواردات من الصين من 1.9% في عام 1996 إلى 9.2% في عام 2022، رغم الثغرات التي كشفتها الجائحة. وتُعد دول الخليج شركاء مهمين في مجال الطاقة بالنسبة للمنطقة، حيث تمثل السلع المصنَّعة في دول الاتحاد من أجل المتوسط الجزء الأكبر من الصادرات إلى أسواقهم. ومع ذلك، تشهد هذه العلاقة تقلبات ناجمة عن تغيّر الأسعار العالمية في قطاع الهيدروكربونات. وقد نمت التجارة مع إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي 1996 و2015، ورغم تباطؤ هذا النمو لاحقًا، صدّرت اقتصادات دول الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2023 ما قيمته 82 مليار دولار أمريكي إلى هذه المنطقة، واستوردت منها ما قيمته 75 مليار دولار.
تركّز الاتفاقيات التجارية في الغالب على السلع، رغم تزايد أهمية الخدمات والتجارة الرقمية: ففي عام 2023، تراجع حجم التجارة العالمية بنسبة 5%، في حين نمت تجارة الخدمات بنسبة 8%. وفي الوقت الراهن، لا تتضمن أحكامًا خاصة بالتجارة الرقمية سوى اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول غرب البلقان، والاتفاقية الثنائية بين تركيا وصربيا، رغم أن هذا القطاع يمثل 25% من إجمالي التجارة العالمية.
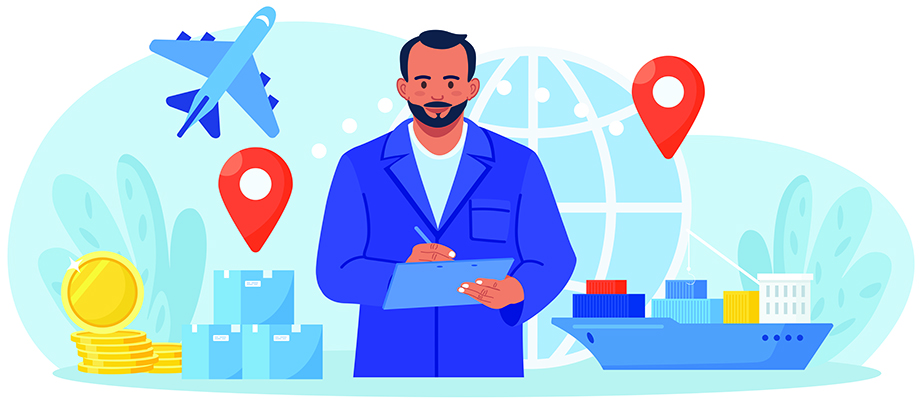
التوصيات السياساتية
تطوير جيل جديد من الاتفاقيات التجارية يشمل الخدمات، والاستثمار، والتجارة الرقمية، والتعاون التنظيمي، مع تحديث وإنفاذ الاتفاقيات القائمة.
تيسير التجارة من خلال تعزيز التعاون الحدودي، والرقمنة، والاعتراف المتبادل بالمعايير، وزيادة الشفافية.
تعزيز التنويع الاقتصادي نحو أنشطة ذات قيمة أعلى، ودعم تطوير سلاسل القيمة الإقليمية للسلع والخدمات.
التمويل

لا يزال التطور والاندماج المالي في المنطقة مجزأ، ويعكس تفاوتات اقتصادية ومؤسسية وجغرافية.
وعلى الرغم من أن القطاعات المالية في المنطقة غير متجانسة إلى حد كبير نتيجة لعوامل منها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو هيكل الأسواق ومدى انفتاحها، فإن السمة المشتركة بينها هي هيمنة التمويل المصرفي. ويُلاحظ محدودية الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، واستمرار القيود، لا سيما في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان.
تزيد المخاطر الجيوسياسية من تعقيد المشهد، خاصة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي وأقساط المخاطر وتشديد شروط التمويل الخارجي إلى تثبيط الاستثمار. وفي بعض البلدان، لا يزال الوصول إلى الائتمان محدودًا بالنسبة للشركات الخاصة. فعلى سبيل المثال، يبلغ الائتمان المحلي الموجَّه للقطاع الخاص في مصر والجزائر وألبانيا نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 80%.
شهد الاستثمار الأجنبي المباشر مرونة نسبية خلال الفترة 2013–2023، مع وجود فروق ملحوظة بين المناطق الفرعية (2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقابل 6.1% في غرب البلقان). وتُعد دول الاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في غرب البلقان، مدفوعةً بعوامل مثل القرب الجغرافي وتكاليف العمالة، كما تمثّل المصدر الرئيسي للاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع استثناء ملحوظ لمصر. وتبرز اقتصادات الخليج كمستثمر رئيسي، حيث بلغت استثماراتها في عام 2023 نحو 11 مليار دولار في المغرب، و2.2 مليار دولار في الجزائر، ومليار دولار في تونس.
تتجاوز التحويلات المالية حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية في العديد من الاقتصادات. ففي عام 2023، شكّلت التحويلات نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، و20% في فلسطين، و10% في الأردن، بينما بلغت 5% في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى. وبالمثل، تجاوزت 10% من الناتج المحلي الإجمالي في ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك. أما من حيث القيمة المطلقة، فكانت مصر والمغرب أكبر المتلقين للتحويلات بين عامي 2020 و2023، حيث تجاوزت في كل منهما 10 مليارات دولار أمريكي. وتأتي معظم التحويلات المالية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان من الاتحاد الأوروبي، رغم أن دول الخليج تُعد أيضًا مصدرًا مهمًا.
لا يزال الوصول إلى الصيرفة يشكّل عقبة أمام الأفراد في جميع أنحاء المنطقة، في حين يحتفظ الاتحاد الأوروبي بأعلى مستويات الشمول المالي. ففي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمتلك أقل من 50% من البالغين حسابًا مصرفيًا رسميًا، وتقل هذه النسبة بشكل ملحوظ بين النساء.
التوصيات السياساتية
تنفيذ إصلاحات حكومية لتعزيز الأسواق والمؤسسات المالية، ومعالجة التجزئة المالية وتسهيل تدفقات رأس المال عبر الحدود.
تعزيز التنويع باستخدام الأدوات المالية مثل أسواق الأسهم وسندات الشركات لاستكمال الخدمات المصرفية ودعم تنمية القطاع الخاص.
تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تبسيط الموافقات، وإزالة الحواجز أمام المستثمرين الأجانب وأنشطتهم لتحسين أطر الاستثمار.
البنية التحتية
لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تطوير البنية التحتية للربط الإقليمي، خاصة في الجنوب، مما يضعف أداء الأنظمة اللوجستية ويؤثر سلبًا على الإمكانات التجارية.
تشكل دول الاتحاد من أجل المتوسط حاليًا ما نسبته 13.4% من الانبعاثات العالمية لقطاع النقل، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 1990. ويمكن لزيادة الاستثمار في بنية تحتية للنقل متعدد الوسائط، مثل خطوط السكك الحديدية عالية السرعة المتصلة بالموانئ لتقليل الاعتماد على الطرق، أن تعزز أداء أنظمة اللوجستيات، وتزيد من حركة التجارة، وتدعم إنشاء سلاسل إمداد إقليمية أكثر استدامة. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود عدة عراقيل، من بينها تجزؤ الأطر التنظيمية، والقيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعقيدات التنسيق، والصعوبات في تعبئة رأس المال، وضعف الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تمثل تبادلات الطاقة في منطقة المتوسط فرصة لتعميق التكامل، نظرًا لإمكانات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المساهمة بتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ. ومع ذلك، لا يزال توليد الكهرباء للفرد في هذه البلدان يشكل تحديًا، في ظل ارتفاع الطلب بأكثر من 200% بين عامي 2000 و2023، مما يجعل من غير المرجح أن تتمكن من تصدير كميات كبيرة من الطاقة المتجددة في المستقبل القريب. ومع استثناءات قليلة، فقد كانت وتيرة تطوير البنية التحتية للنقل والطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطيئة.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في البنية التحتية الرقمية، فإن توسيع خدمات الإنترنت عريض النطاق لا يزال محدودًا في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بدول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ متوسط الاشتراكات 76 اشتراكًا للهاتف المحمول و7.8 اشتراكات ثابتة لكل 100 نسمة. ويعتمد نجاح المبادرات الرامية إلى تحسين الاتصال، مثل “كابل ميدوسا البحري”، على مدى قدرة الدول على توسيع شبكات الاتصالات داخل حدودها.

التوصيات السياساتية
زيادة المشاركة في منصات التعاون الإقليمي لتعزيز الثقة والتنسيق واتساق السياسات، ومواءمة المعايير، والتخطيط العابر للحدود، واستمرارية شبكات البنية التحتية وسلاسل التوريد.
دعم تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، خاصة في جنوب المتوسط، ودمجها في شبكات الطاقة المحلية والإقليمية.
تحسين البنية التحتية للنطاق العريض في جنوب المتوسط لتوسيع الاتصالات عالية السرعة والربط بين الشمال والجنوب.
تنقل الأفراد
استمرت حركة التنقّل في الارتفاع، مدفوعة بالضغوط الديموغرافية، وعدم توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل، والتفاوتات الاقتصادية.
يمكن أن يكون للهجرة آثار إيجابية على التنمية، لكن ارتفاع معدلات الهجرة من غرب البلقان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثار مخاوف من هجرة الأدمغة وفقدان العمالة الماهرة. ففي دول الاتحاد من أجل المتوسط في منطقة غرب البلقان وحدها، يعيش ربع السكان خارج بلدانهم. وفي المقابل، تسهم شيخوخة سكان الاتحاد الأوروبي وتقلص قوته العاملة في تعزيز الدور التاريخي للهجرة في سد فجوات السوق. وقد أطلق الاتحاد عدة اتفاقيات، منها “شراكات المواهب” التي تسهّل مواءمة تنمية المهارات الأجنبية مع متطلبات السوق المحلية، لدعم هجرة اليد العاملة.
وقد نمت الهجرة داخل الاتحاد من أجل المتوسط بنسبة 6% بين عامي 2021 و2024، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة. ويستضيف الإقليم حاليًا أكثر من 34 مليون مهاجر من داخل الاتحاد، مقارنة بـ19 مليونًا في عام 1990. ويمكن أن تُعزى الحصة الأكبر من هذه الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أعداد المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان في تزايد منذ عام 2021. ففي عام 2022، تم تسجيل 1.39 مليون مهاجر جديد داخل الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 63% من إجمالي الحركات داخل الاتحاد من أجل المتوسط. وكانت الدول الأعلى من حيث أعداد المهاجرين منها في ذلك العام هي رومانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وبولندا.
تمثل التحديات الهيكلية مثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وعدم توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل، مشكلة مستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول غرب البلقان. وتشير الاستطلاعات إلى أن الاهتمام بالهجرة مرتفع: ففي المتوسط، يفكر نحو 35–40% في الهجرة، ويصل هذا المعدل إلى 46% في تونس، و44% في ألبانيا، و42% في الأردن، و42% في الجبل الأسود. وتشمل أبرز وجهات المقصد في الاتحاد الأوروبي فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا. ويعد الخليج أيضًا وجهة مهمة لمهاجري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما من مصر، حيث تضاعفت أعدادهم ثلاث مرات بين عامي 2000 و2024 لتصل إلى 3.9 مليون مهاجر.
في عام 2023، وصل أكثر من 274,800 مهاجر غير نظامي إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وتشير البيانات إلى زيادة بنسبة 35% في أعداد الوافدين غير النظاميين في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى مستويات منذ عام 2016. كما تسبب تغيّر المناخ في نزوح 305 آلاف شخص جديد في الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2022، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي. وفي الآونة الأخيرة، أدت الزلازل في تركيا وسوريا والمغرب عام 2023، والفيضانات في إسبانيا عام 2024، إلى زيادة حالات النزوح الداخلي.
وعلى الرغم من أن السياحة لا تزال تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن عدم الاستقرار الإقليمي قلّل من أثرها الاقتصادي، لا سيما في لبنان والأردن ومصر. وقد تعافت السياحة أو تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان، لكنها أثارت مخاوف متزايدة بشأن الضغوط على المجتمعات المحلية والبيئة. وظل معدل التوظيف في هذا القطاع مستقرًا في السنوات الأخيرة، حيث يمثل نحو 15% من إجمالي العمالة في المنطقة.
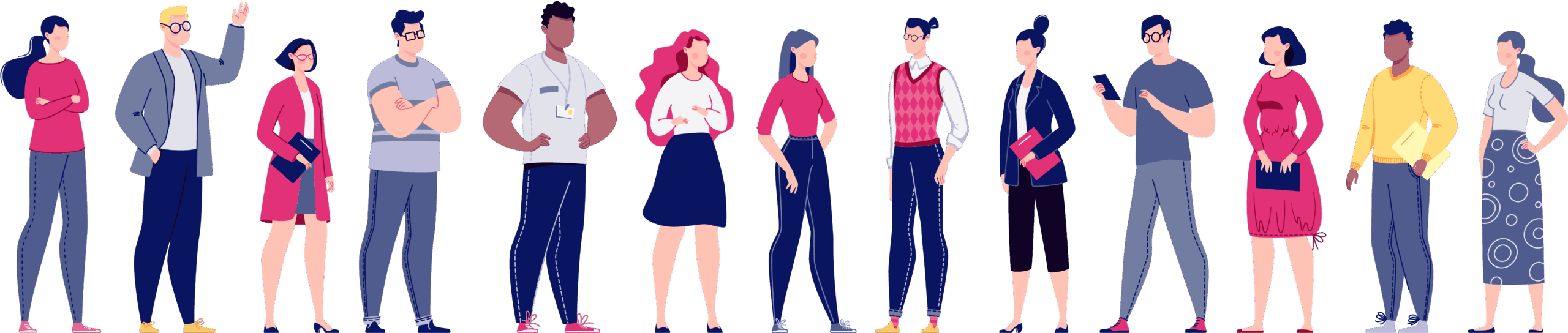
التوصيات السياساتية
تحسين إدارة هجرة اليد العاملة من خلال مراقبة التدفقات، وإعطاء الأولوية للاتفاقيات التي تدعم تنمية المهارات وتلبي احتياجات كل من بلدان المصدر وبلدان المقصد.
تشجيع ممارسات السياحة المستدامة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والحد من الآثار البيئية، وتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة على المدى الطويل.
التعليم العالي والبحث العلمي
تتزايد أهمية التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التكامل والتعاون الإقليميين، ومع ذلك لا يزال تطوّرهما غير متوازن بشكل كبير.
بينما تمتلك دول الاتحاد الأوروبي أطرًا تعليمية قوية تدعم التعاون والتنقّل عبر الحدود، بالإضافة إلى معايير موحّدة، فإن أنظمة التعليم في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير مندمجة لا مع أوروبا ولا فيما بينها. وتعكس أنماط التنقّل الحالية تفاوتات في الاستثمار، والبنية التحتية، والقدرات المؤسسية، وهي في الغالب غير متكافئة، إذ تهيمن عليها التدفقات من الجنوب، وتتأثر بدرجة كبيرة ببرامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج “إيراسموس+” للتبادل التعليمي. ففي عام 2022، بقي نحو 65% من جميع الطلاب المتنقلين من دول الاتحاد من أجل المتوسط داخل الإقليم، معظمهم في دول الاتحاد الأوروبي (60%).
تستثمر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول غرب البلقان المنضوية في الاتحاد من أجل المتوسط عمومًا أقل في التعليم العالي مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤثر على القدرة التنافسية وجهود التكامل. ففي عام 2023، استثمرت إسرائيل 6.35% من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث والتطوير، وهي نسبة تفوق بكثير باقي دول الاتحاد من أجل المتوسط. وفي العام نفسه، بلغ متوسط إنفاق دول الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير 1.58% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من إنفاق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (0.68%)، وشمال إفريقيا (0.66%)، وبلاد المشرق (0.57%)، ودول غرب البلقان (0.29%).
لا تزال الفجوات بين الجنسين قائمة، حيث يفوق عدد الرجال، على سبيل المثال، عدد النساء في وظائف البحث العلمي. وتشكل النساء نحو 48% من الطلاب الوافدين في التعليم العالي المتنقل في دول الاتحاد من أجل المتوسط التي تتوافر عنها بيانات، وتنخفض هذه النسبة إلى 40% في شمال إفريقيا. ومع ذلك، شكّلت النساء 63% من المتعلمين المتنقلين و57% من الكوادر الأكاديمية المشاركة في برامج “إيراسموس+” عام 2022.

التوصيات السياساتية
تعزيز القدرة على التعاون الإقليمي من خلال زيادة التمويل العام للتعليم العالي والبحث، لا سيما في بلدان جنوب المتوسط. خلق حوافز للباحثين والجامعات والشركات للمشاركة في برامج التمويل الدولية.
زيادة فرص التنقل في مجال التعليم والبحث بالإضافة إلى التبادلات الافتراضية والتنقل قصير الأجل. سيساهم تنفيذ الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات في التعليم العالي في تحسين الاعتراف بالمؤهلات وتبادل المعلومات.
خلفية
في كانون الثاني/يناير 2017، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط «خريطة طريق الاتحاد من أجل المتوسط للعمل» التي تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد في دفع التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة المتوسط. وقد حدّدت خريطة الطريق الحاجة إلى تقرير تقدّم حول التكامل الإقليمي من أجل متابعة الاتجاهات، وتقييم التقدّم المحرز عبر الزمن، وإرشاد عملية صنع السياسات.
تقرير 2021 حول التقدّم في التكامل الإقليمي في الاتحاد من أجل المتوسط أُعِدَّ من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بدعم مالي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
Share this


